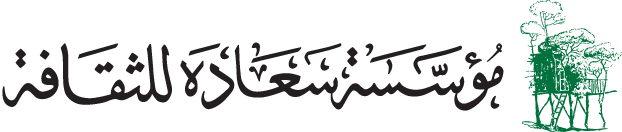مدخل لقراءة سعاده 1920 ... 1930
المصدر: جريدة البناء - العدد 87/1033 18/11/1972
هذا البحث هو مقدمة موجزة لقراءة سعاده ما قبل تأسيس الحزب. وقد رأينا انه لا بد من القاء بعض الضوء على الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية التي وقعت في سورية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين نظرا لان سعاده قد عايش افكار وتجارب تلك الفترة واستفاد من حسناتها فأسس فيما بعد الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان "ضربة قاضية على البلبلة الفكرية الروحية وبدء اتجاه الأمة نحو قضيتها التي هي قضية حياتها ومصيرها ومطالبها العليا".
من هنا كان من الضروري ان نقدم بعض الملامح للأحداث السياسية والفكرية التي واجهتها سورية، والتي اثرت في تطور وتكوين فكر سعاده في العشرينات.
مما لا شك فيه ان دراسة فكر سعاده بشكل مجرد عن الواقع يقود بالطبع الى مواقف ضيقة وجاهلة. فالسمة الثورية النضالية التي اتسمت بها الحركة السورية القومية الاجتماعية في الثلاثينات والأربعينات وخلال فترة قيادة سعاده لها بالحصر، سمة النضال ضد القوى الرجعية والإستعمارية والصهيونية هي نتيجة لأفكار وتجارب سعاده خلال فترة شبابه في العشرينات. وسعاده في العشرينات ليس مفكرا اصلاحيا: متأثرا بالأفكار الإصلاحية التي غزت سورية ومصر من الثورة الفرنسية بعد حملة نابليون، بل هو ثائر رائد اختلف عن سائر المفكرين والأدباء الطليعين بأنه اختط منهجا ثوريا منذ كتاباته الأولى وهذا النهج الثوري جسده في تجارب تنظيمية لمجموعات السوريين الموجودين في المغترب البرازيلي، ومن ثم في تجربة تاريخية رائدة في بيروت حين أسس الحزب السوري القومي الاجتماعي.
في رسالة سعاده الى حميد فرنجية التي يشرح فيها دوافعه لتأسيس الحزب، مدخل جيد لدرس العوامل والمؤثرات والدوافع للتأسيس. فهو يقول " كنت حدثاً عندما نشبت الحرب الكبرى ولكني قد بدأت أشعر وادرك. وكان اول ما تبادر الى ذهني وقد شاهدت ما شاهدت وشعرت بما شعرت وذقت ما ذقت مما منى به شعبي، هذا السؤال.. ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟".
وبدأ سعاده بحثه عن جواب للسؤال المتقدم عندما وضعت الحرب اوزارها. وبسفره في اوائل 1920 الى المهجر شاهد الأحقاد المذهبية التي بعثت من مراقدها وتمزق شعبنا شيعا ومذاهب، وسيطرة المستعمرين.
وقرر سعاده بعد درس أولي منظم ان فقدان السيادة القومية هو السبب الأول فيما حلّ بأمتنا. وبدأ درسا منظما لمعنى الأمة وعوامل نموها.
اما فقدان السيادة القومية فقد كان ممثلا بسيطرة استعمارية على مواردنا، وبتعميق التناقضات المذهبية والعرفية، وسيطرة للرأسمال الغربي بصورة خاصة على جميع المؤسسات والموارد المتوفرة في تلك الفترة.
لقد كانت العلاقات الإقطاعية هي العلاقات السائدة في مجتمعنا الفلاحي. وكان الإقطاعيون من رجال الدين يلعبون دورا كبيرا في التسلط والنشاط السياسي. كما كانوا يملكون قسما كبيراً من الأراضي حيث يستغل الفلاحون ويعيشون في اوضاع مزرية.
ومن الإقطاع الديني الى الإقطاع الأرضي في ظل العثمانيين حيث كان للسلطة العثمانية أراض مشاعية شاسعة يعيش فيها الفلاحون السوريون في أبشع ظروف الإضطهاد.( تركيزنا على الحالة التي يعيشها الفلاحون ناتج عن ان المجتمع السوري خلال تلك الفترة هو مجتمع فلاحي ريفي تنعدم فيه العلاقات الإنتاجية الرأسمالية الكبيرة).
من الإقطاع الديني والعثماني الى التمزق العرقي والمذهبي. فالتضعضع الاقتصادي رافقه تضعضع اجتماعي ترك نتائج سيئة لا تزال فاعلة حتى يومنا هذا. فالحوادث الدينية الدموية التي نشبت في سورية بين فئات الشعب الواحدة قادت ايضا الى تدخل الدول الكبرى ذات المصلحة في بسط نفوذها على المنطقة، عامدة الى تفكيك السلطنة العثمانية وايهام بعض الفئات المذهبية بان هذه الدولة الكبرى او تلك هي الحامية لمصالح الفئات المذهبية.
نظام الامتيازات موطىء قدم للاستعمار الغربي
لقد كان نظام الامتيازات الذي نعم به الاجانب (الاوروبيون) في الامبراطورية العثمانية سلاحا هاما للتغلغل الاقتصادي الاجتماعي ومن ثم السياسي العسكري. فقد بدأت هذه الامتيازات بشكل صغير جدا ومن ثم تطورت حتى ساهمت في القضاء على الامبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى.
وقد حملت هذه الإمتيازات بالإضافة الى بذور السيطرة الإستعمارية الغربية وتعميق الخلافات المذهبية والعرقية في شعبنا، حملت بذور الفكر الاصلاحي الأوروبي وخاصة افكار الثورة الفرنسية.
بداية هذه الإمتيازات كانت عندما منح السلطان سليمان القانوني فرانسوا الأول ملك فرنسا بعض الإمتيازات في القرن السادس عشر عام (1535) . ثم ما لبثت هذه الإمتيازات ان ازدادت رويدا رويدا. ويقول سعاده في خطابه في الاول من آذار سنة 1938 ان هذه الإمتيازات كانت تساهم في بسط نفوذ الدول الكبرى شيئا فشيئا.
والحقيقة انه بعد حدوث الثورة الصناعية في اوروبا تطلعت الدول الأوروبية نحو سورية لمركزها الإستراتيجي في الطريق الى الهند، وكانت حملة نابليون على مصر ثم اهتمام انكلترا بالمحافظة على الطريق الى أسواقها في الهند، كل هذه الأحداث قد اثارت المنافسة بين الدول الأوروبية المتقدمة صناعيا على اقتسام تركة " الرجل المريض".
اننا نسهب هنا في شرح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية قبل تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، لأننا كما ذكرنا في بداية بحثنا ان أي دراسة لظاهرة تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي لا يمكن ان تتم بمعزل عن دراسة التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية في سورية قبل التأسيس، وكذلك دراسة حياة سعاده قبل التأسيس في الوطن وفي المغترب حيث تتضح من خلال كتاباته تأثره بالأفكار التي عاصرها واتجاهه رويدا رويدا نحو منحى جديد في النهج والتحليل لواقع المجتمع السوري وافتراقه الجذري وخاصة في المنحى القومي عن سائر الأفكار المعاصرة له. وقد أشار سعاده بصورة شبه مسهبة في خطابه اول آذار 1938 وفي مقاله " شق الطريق لتحيا سورية" الى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاينها قبل تأسيس الحزب.
يشير لاوتسكي في كتابه " تاريخ الاقطار العربية الحديث" الى مدى تأثير الفتن الدينية والإقطاعية على مجتمعنا الذي كانت تشمل الزراعة فيه من 60 الى 70 % فيقول " أدت الحروب المتكررة والفتن الاقطاعية، والجفاف الى خراب الفلاحين وتدهور الزراعة الى اقصى حد وكانت تنقرض قرى بأكملها. ولم يبق في نهاية القرن الثامن عشر سوى 400 قرية في ايالة حلب والتي كانت تزيد على 3200 قرية في مطلع القرن السادس عشر".
اذن من الفتن الدينية التي قسمت شعبنا ومزقته شيعا وتغلغل النفوذ الأجنبي التدريجي الى سورية انتقل شعبنا الى مرحلة جديدة تمخصت في نهاية الامر عن تفكيك نهائي للسيطرة التركية ودخول قوات الحلفاء سورية وبدء مرحلة جديدة من الصراع.
ويعطي بدر الدين السباعي في كتابه " أضواء على الرأسمال الاجنبي في سورية" صورة عن تغلغل الرأسمال الغربي الذي قاد في النهاية الى السيطرة الإستعمارية فيقول "بين 1850 – 1914 تم تحول امبراطورية " الرجل المريض" الى نصف مستعمرة تحت نفوذ اهم الدول الإستعمارية آنذاك: انكلترا، فرنسا، المانيا. وفي عام 1914 احصي نصيب هذه الدول من الرأسمال الأجنبي الموظف في الامبراطورية فكان : 45,4 % لألمانيا 25,9 لفرنسا و 16,9 لانكلترا، اي 88,2 % في حين كان نصيب الدول المتطورة الأخرى كالنمسا وايطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا وغيرها 11,8 % ".
الإرساليات الأجنبية والتحول الجديد
وفدت الإرساليات الأجنبية الى سورية في منتصف القرن الثاني عشر وكانت أولى هذه الإرساليات مدرسة عين ورقة ثم بدأت بالإزدياد. نشرت هذه الإرساليات الروح العلمانية، ثم ما لبثت ان لعبت دورا في خدمة الإستعمار والنظم الرجعية التي اقامها وذلك بتخريجها مجموعة من الشبان ارتبطت مفاهيمهم وافكارهم بالغرب الإستعماري. وهؤلاء هم اليوم منظّرو ومفلسفو " الكيانات" التي اقامها المستعمر في أمتنا بعد تمزيقها في اتفاقية سايكس – بيكو. ولكن لا بد من الإشارة الى الدور الذي لعبته هذه الارساليات في نشوء الفكر الوطني وتنمية هذا الظاهرة عبر التصادم الحضاري مع الغرب فجاءت افكار الثورة الفرنسية لتكون المعين الأساسي لمفكري وأدباء المرحلة التي سبقت النهضة السورية القومية الاجتماعية.
لقد ظلت الحياة في سورية تسير ضمن مؤسسات المذاهب الدينية والإقطاعية والعشائرية، ولكن مجموعة جديدة من الأفكار بدأت بالظهور في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وهذه الأفكار كانت تدعو الى الاخاء والحرية والمساواة والإستقلال ويمكننا اعتبار هذا المرحلة محور النهضة الوطنية الحديثة في سورية. ومفكرو هذه المرحلة حملوا فكراً يتراوح بين الاصلاح والثورة. وقد كانوا بمعظمهم أدباء ومفكرين وفنانين قد اتجهوا في منحى معاد للإستعمار ودعوا الى الإستقلال كل على طريقته.
وهؤلاء هم ظاهرة مرحلية في تفكيرنا السياسي والاجتماعي والثقافي. فالملامح الإنسانية والوطنية هي القاسم المشترك في مجمل كتاباتهم. ومع التوكيد على أن هؤلاء كانوا في مرحلة متقدمة ولكنهم بالنسبة لعصرهم والظروف التي واجهوها افتقدوا "فكرة واضحة لتأسيس الحياة القومية ومصالح الشعب السوري، بذلك اختلطت شؤون كثيرة سياسية واقتصادية ودينية وتدخلت بعضها ببعض وأصبحت التعابير كلها مترادفة، وكلها تعني التخلص من تركية" (سعاده، خطاب اول آذار 1938) وان اختلاط الشؤون السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية يبدو جليا في " أدب" هؤلاء المفكرين.
فبطرس البستاني نموذج واضح للإتجاه الوطني العلماني، ففي صحيفته "نفير سوريا" كان يدعو الى الوحدة والوئام بين أبناء الطوائف وللإتحاد في طلب العلم لان العلم يقود الى المعرفة والمعرفة الى موت التعصب الطائفي وولادة المثل العليا الواحدة التي تجمع بين أبناء البلاد.
فمجلته "الجنان" سنة 1870 كانت منبرا للوطنية شعارها "محبة الوطن من الإيمان". وللمزيد من فهم البستاني كظاهرة ونموذج من الإتجاه الوطني الذي ساد في تلك الفترة لا بد من مراجعة لكتاباته وخطبه التي يدعو فيها الى تعليم المرأة والقضاء على الفساد والتعصب والنهوض للحاق بالأمم المتمدنة وضرورة النقل عن الإفرنج كما نقلوا عنا لتغذية ثقافتنا.
هذه الدعوات التي اطلقها البستاني هي بالطبع دعوات تقدمية وطنية ولكن البستاني كغيره من أدباء تلك الفترة اختلطت عنده مسألة المفهوم القومي للأمة فعمل ودعا للإستقلال والنهوض بصورة مطلقة فخرجت هذه الدعوة عن المعنى القومي الصحيح كما يقول سعاده في رسالته الى حميد فرنجية.
ويقدم جورج عطية في اطروحته "نشوء فكرة سوريا الكبرى وتطورها" تحليلا وصورة واضحة عن الفكر السابق للنهضة القومية الاجتماعية فيقول "مع ان مفهوم الأمة كما هو ظاهر من مجرد القول بالعثمانية غير واضح لهؤلاء الكتّاب فإن أكثرهم كان يطالب بالإصلاح والمساواة في الحقوق والواجبات بين الشعوب العربية وبين الأتراك على أساس الأمة الواحدة. وكان بعضهم يصارع أساليب الحكم التركي كفرح انطون مثلا، الذي ترجم رواية (عهد الارهاب لديماس) ونشرها سلسلة في مجلته الجامعة العثمانية وأخذ يحتال لإرسالها الى سورية خوفا من وقوعها تحت الرقابة العثمانية التي كانت تتبع اخبار وصولها الى سورية بيقظة وتنبه (وارد ذلك في مقدمة فرح انطون للرواية المذكورة). ولكنه في الوقت نفسه ينشئ مجلته الجامعة العثمانية ويقصد بها وقوف الشرق معا في السراء والضراء لكي يستطيع الشرقيون ان يسيروا مع التيار الغربي فلا يدوسهم. وأشار في العدد الاول من مجلته الى انه يجب قيام مدارس جديدة يكون اساس تعليمها حب الوطن والأمة وتعليم ما هو الوطن وما هي الأمة. وان تسير هذه المدارس على طرق التعليم الحديثة ووسائل التربية الحديثة وان يدخل اليها عناصر الأمة كلها فتربى فيها على مقاعد واحدة وتتلقى دروسا واحدة ومبادئ واحدة حتى تخرج الى العالم بقلوب واحدة وافكار واحدة لتقوية جدار الوطنية العثمانية" (فرح انطون ملحق مجلة السيدات والرجال سنة 1923).
وبالرغم من التعسف والاضطهاد التركي فلقد انتهت توجيهات فرح انطون الى "تقوية جدار الوطنية العثمانية" وهذا دلالة واضحة على بلبلة وعدم وضوح مفهوم الأمة والشأن القومي لدى مفكري ومناضلي تلك المرحلة. فكان البعض منهم يدعو الى امة اسلامية او جامعة اسلامية على اساس تعاليم القرآن وتقاليد الاسلام كجمال الدين الافغاني ومحمد عبده، ويرفض هؤلاء في افكارهم فصل الدين عن الدولة وعدوا ذلك محاولة لنسف بناء الدين الاسلامي، بينما دعا الآخرون الى قيام أمة واحدة مع العثمانية يكون مركزها مقر الخلافة. ومنهم من دعا " لإنشاء إمبراطورية عربية وإعادة عهد هارون الرشيد السيء من الوجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية" (سعاده في اول آذار ص 22) وبعد تقسيم سورية في سايكس- بيكو وتشجيع المستعمرين الغربيين لسياسة التجزئة العنصرية الدينية نشأ اختلاط اخر بالدعوة الى "أمة لبنانية" حيث يمكننا ان نعود بأصول هذه الدعوة الى "الحوادث الدينية الدموية المعروفة "بحركة الستين" وهي حوادث القتال بين المسيحيين والدروز، التي انتهت بتدخل الدول الكبرى ذات مصلحة في تفكيك السلطنة العثمانية وسط نفوذها على هذه الأرجاء ووضع نظام خاص لجبل لبنان يحصل بموجبه الأمان للمسيحيين المقيمين فيه الذين يؤلفون اكثريته" (سعاده في اول آذار ص 24).
وسنأخذ الان نموذجا اخر بعد فرح انطون، وبطرس البستاني وهو جبران خليل جبران.
فجبران خليل جبران من الكتّاب السابقين للنهضة القومية الاجتماعية. ويقول سعاده عنه انه "الشفق الذي يسبق الأنوار الساطعة، أنوار النهضة القومية الاجتماعية" وهو "الــ prototype للنهضة الجلية الكاملة، والاهتزازات الحية السابقة الحركة الحيوية الكبرى" (جريدة النهضة مقدمة مقال العهد الجديد بيروت 1937).والعديد من كتابات جبران كانت محرضا للشعور القومي وداعيا للثورة على المستعمرين وللوحدة السورية. وبالرغم من ان لجبران بعض الكتابات الذي يعترف فيها صراحة بقوميته السورية لكن المفهوم القومي للأمة قد اختلط عليه ايضا، وسنأخذ امثلة على قولنا هذا من رسائله الخاصة الى ماري هاسكل والتي نشرت مؤخرا وقدم عرضا لها توفيق صايغ في كتابه "أضواء جديدة على جبران"، فهو يدعو مثلا الى ان تقوم فرنسا بتدريب سوريا على الإستقلال لمدة عشرين سنة كي تتعلم ان تحكم نفسها ولكنه في كتابات لاحقة وبعد وضوح السيطرة الإستعمارية الفرنسية على سوريا يدعو الى الحكم الذاتي. يتحدث في رسالة في مطلع تشرين الثاني 1914 عن رغبته في العودة "... وهذا سيسهل تثبيط عزيمة تركيا على الأقل، وعندئذ بوسع سوريا ان تستدعي فرنسا كي تتولى تدريبها لمدة عشرين سنة الى ان تتعلم كيف تحكم نفسها. ويمكن اعطاء البلاد العربية الى انكلترا، عند البحر الاحمر، وهي المنطقة التي تريدها، وتأخذ فرنسا سوريا".
وتظهر البلبلة للمفهوم القومي في بعض كتاباته حين يتحدث عن "اللبنانية"، فيقول مثلا في نبذة من يومياته " جبل لبنان جزء من الإمبراطورية التركية، يختلف اختلافا كبيرا عن بقية الأجزاء كلها، انه اشبه بمونتفيغرو، لم يقهر ... لسنا كباقي السوريين اننا لا نشبههم بشكل، ومشاعرنا ومشاعرهم تتضارب. ان فينا دماء فرنسية وانكليزية وأوربية اخرى منذ زمن الصليبيين ونحن جميعا مسيحيون". وفي نبذة اخرى عام 1917 يقول لماري هاسكل "ان اللبنانيين يختلفون علن السوريين اختلاف الأميركيين عن المكسيكيين".
ان هذه "اللبنانية" هي نتيجة لعدم وضوح معنى الأمة والقومية عند جبران، ونقاط الضعف هذه قد حاول استثمارها بعض المعقدين من منظري "اللبنانية" في لبنان واصدروا كتبا حول هذا الموضوع. ولكن جبران خليل جبران هو سوري قومي بعقله ووجدانه ومجمل كتاباته تظهر بوضوح قولنا هذا.
موقف اخر لجبران يهاجم فيه " فيصل الذي تستخدمه انكلترا" فيقول ... يجيء هو ويطالبك بدمشق وسوريا المسلمة. أي انه لأجل خاطر انكلترا، سيقسموننا بدلا من سوريا موحدة الى سوريا مسيحية (لبنان) وسوريا يحكمها العرب (وهذا يعني سوريا تحت فيصل – لان فيصل تحت سيطرة انكلترا) وفلسطين تحت انكلترا" (أضواء جديدة على جبران لتوفيق صايغ ص 153). ويستمر في حملته على فيصل في رسالة مؤرخة في 18 نيسان 1920 معارضا استسلام فيصل الملك في سوريا "لأني لا اريد أن يأخذها العرب" ولأن هذه المحاولة "محاولة سياسية واستعمارية" ويصف احتلال فيصل لدمشق " بالعمل الوسخ". ولكن موقفه هذا من فيصل الذي يحوي وجهة نظر في الإتجاهات التي ساعدت فيصلا في اعلان نفسه ملكا على الشام، نقول هذا الإتجاه قد تغير بعد معركة ميسلون فدعا الى وحدة سورية واشاد بالمواقف الوحدوية ومنها موقف فيصل.
موقف ثالث يؤكد فيه جبران هذه المرة قوميته السورية في رسالة منه الى اميل زيدان نشرت في الهلال عدد مارس 1943 ويتحدث فيها عن الحوادث السياسية التي جرت في سورية سنة 1919 – 1922 يقول " أنا من القائلين بوحدة سورية الجغرافية وبإستقلال البلاد تحت حكم نيابي وطني .. ( ويتابع في رسالته هذه القول) اذا كنا لا نريد ان نمضغ ونبلع فعلينا ان نحافظ على صبغتنا السورية، حتى وان وضعت سوريا تحت رعاية الملائكة".
ان المقاطع التي اثبتناها من جبران تثبت بدون ادنى شك مدى البلبلة الفكرية في المنحى القومي وهذا ما سيطر على جميع كتابات المفكرين الطليعين أمثال الريحاني، وفرح انطون وخليل سعاده والبستاني وغيرهم. ولكن هذا لا يقلل من أهمية جبران ورفاقه لانهم لم يكونوا متمكنين من الدروس الاجتماعية العلمية بدرس شخصية الجماعة وواقعها الاجتماعي وظروفه وطبيعة العلاقات الناتجة عنه والتي تحدد مقدار حيوية الجماعة ومؤهلاتها للبقاء. وهذا ها أنجزه سعاده بعد درسه "المسألة القومية ومسألة الجماعات عموماً والحقوق الاجتماعية وكيفية نشوئها" (رسالته الى حميد فرنجية) وهذه هي نقطة الإفتراق الرئيسية بين سعاده ومن سبقه. بدراسات سعاده اسست القضية القومية أاول مرة على العلوم المتقدمة ونبه الشعب لمصالحه ونظم للنضال من اجل هذه المصالح. فالوطنية السورية التي تكلم عنها جبران وخليل سعاده اتخذت منحى عربيا بعد معركة ميسلون، فقادت تغيرات الأحداث المفكرين الوطنيين الى مواقف متخبطة، اما سعاده فقد اتجه الى دراسة الوطنية السورية التي كتب عنها مقالات عديدة في كتاباته الأولى، نقول اتجه الى دراستها دراسة علمية قادته الى القومية السورية التي هي يقظة الأمة وتنبهها لوحدة حياتها وشخصيتها ومميزاتها ووحدة مصيرها. اذن كان الإنتقال واضحا من الوطنية السورية، التي هي محبة الوطن والدعوة الى الإستقلال والحرية والآخاء والمساواة الى سائر الشعارات التي رفعت في كتابات جبران وغيره، الى القومية السورية التي حددت بناء على الدراسات الاجتماعية المتقدمة.
ولقد قدم سعاده رأيه بجبران فاشاد به لوعيه واتجاهه الوطني قائلا " ان جبران اعظم الكتّاب الذين نبهوا الأمة وايقظوها ولكنه لم يعين لها الهدف او لم يضع لها الاتجاه لو لم يفتح لها طريق النجاة. وهو في بعض اثاره كان تفكيره قوميا كاملا من حيث وصف الداء بكل ما فيه من خطر" (الزوبعة العدد التاسع 30 نوفمبر 1940) ان استطرادنا في الحديث عن جبران يكمن في أننا أخذناه نموذجا متقدما للفكر الوطني الذي ساد قبل النهضة القومية الاجتماعية.
من الافكار الى الأحزاب
رأينا بوضوح بلبلة الاتجاه القومي في نماذج من كتابات فرح انطون والبستاني وجبران، وقد انعكست هذه البلبلة على الجمعيات والأحزاب التي اسست وكان شعارها العمل لإستقلال سورية. فقد شكلت هذه الأحزاب اسلوبا متطورا في الفكر السياسي والوعي الاجتماعي في تلك الفترة وكانت البيئة الاجتماعية المتناقضة التي ولدت فيها هذه الأحزاب كانت ذات ثقافة متدنية سواء في المهاجر ام في الوطن، وكان المجتمع السوري كما ذكرنا سابقا مجتمعا زراعيا فلاحيا متخلفا يخلو من الصناعات وتسوده العلاقات الاقطاعية والطائفية.
ولقد ظهرت معظم هذه الجمعيات والأحزاب بعد ان رضخت الدولة العثمانية للضغط الداخلي والخارجي معا واضطرت الى تعديل بعض مظاهر الحكم فيها بإعلانها الدستور سنة 876 . وسوف نقدم بعض النماذج عن اهداف هذه الجمعيات والأحزاب، وكل هذه النماذج تؤكد ان هذه الأحزاب والجمعيات "عملت طويلا لغايات مبهمة في الوطنية بعيدة عن تنظيم الشعب وعقائده وعن ايجاد المؤسسات الصالحة للعمل القومي، وعن وضع قواعد تربية اجتماعية سياسية جديرة بتوليد المعنويات القومية الكامنة في نفسية الأمة " ( سعاده خطاب اول آذار 1938).
جمعية الأخاء العربي العثماني :
كان مقر هذه الجمعية في الاستانة ونص قانونها الأساسي ان لا تضم غير العرب، فهي جمعية قومية، مخلصة للدولة العثمانية تسعى للمحافظة على احكام الدستور بالتعاون مع جمعية الآخاء والترقي (القائد العام للجيش الرابع العثماني ايضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي بعاليه ص 7 الإستانة مطبعة التنين 1334 هـ).
على شاكلة هذه الجمعية ومبادئها نشأت العديد من الجمعيات ومعظمها لم تستطع ان تتخلص من فكرة الوحدة مع الأتراك وذلك بسبب الرابطة الدينية. وكانت هذه الجمعيات والأحزاب متناقضة متنافرة تناقض وتنافر رجالها الذين لم يستطيعوا تحديد قضيتهم القومية الجامعة مصالح وحقوق الشعب السوري. نموذج اخر على هذه الجمعيات وقراراتها، المؤتمر الذي عقد في باريس 1913 وحضره وفود عن حزب اللامركزية في القاهرة وجمعية الإصلاح البيروتية والمنتدى الأدبي ومندوبون عن السوريين في امريكا وبعض شباب العراق وذلك " لبسط مطالبهم امام الأمم الأوروبية ومصارحة الدولة العثمانية " (عزة دروزة حول الحركة العربية الجزء الاول ص 38 ) وقد صرح رئيس هذا المؤتمر في باريس بقوله : " نحن نتمسك بالوحدة السياسية (مع تركيا) رغبة منا في ايجاد مجموع عثماني يرتقي فيه مجموعنا العربي بدون حائل يقف في طريقه واملاً بقيام حكومة رشيدة تكون لنا مشاركة في أمورها" (كتاب سورية للسوريين تأليف مسلم طبع بيروت 1339 هـ).
هذا التخبط بين العثمانية والعربية واللبنانية استمر في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. وسوف نقدم فيما يلي عرضا مقتضبا للأوضاع السياسية الاجتماعية التي سادت بعد الحرب والتي شاهدها سعاده نفسه حين اقامته في الشوير وفي مدرسة برمانا اثناء فترة الحرب وبعدها.
الحرب العالمية الأولى والمرحلة الجديدة
عندما وقعت الحرب العالمية الأولى نفذ الاتراك سياسية القتل الجماعي لجميع الفئات الوطنية العاملة في الوطن وزاد الطين بلة الضائقة الاقتصادية الجديدة التي وقعت والتي سببت مع مجيء الجراد المجاعة وتصف تقارير القنصل البريطاني في بيروت والتي نشرت في وثائق وزارة الخارجية البريطانية الوضع في سوريا ولبنان بصورة خاصة وتعطي صورة دقيقة عن هذا الوضع ففي وثيقة مؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1920 موجهة الى ايرل كيرسن يقول القنصل البريطاني ما معناه انه في اواخر سنة 1915 جاء الجراد وقضى على كل المواسم وبدأ الناس يعيشون حالة مزرية بسبب الجوع سنة 1916، وفي السنوات 1917 و 1918 سيطر الجوع على المنطقة بكاملها وادى الى موت ثلث السكان واضطر قسم كبير من السكان الى الهجرة. ويتابع القنصل في تقريره هذا وصف الحالة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا بصورة عامة ويقول ان القرى التي زارها قبل الحرب اصبحت الان مقفرة، وان ما تبقى من الأهالي يعيشون على الأموال التي يرسلها ذويهم من أميركا. وقد تأثر سعاده بالوضع المزري الذي يعيشه شعبنا وظهر ذلك في العديد من كتاباته وهذا ما دفعه الى تأسيس الحزب، فهو يقول في مطلع رسالته الى حميد فرنجية " كنت حدثا عندما نشبت الحرب الكبرى سنة 1914 ولكني كنت قد بدأت أشعر وأدرك. وكان اول ما تبادر الى ذهني، وقد شاهدت ما شاهدت وشعرت بما شعرت، وذقت ما ذقت مما مني به شعبي، هذا السؤال: " ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟ ".
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بدأت مرحلة جديدة من النضال الوطني. وكانت الطعنة الأولى التي قدمها الحلفاء الى شعبنا انتزاع سورية من تركيا وتقسيمها بموجب معاهدة سايكس – بيكو السرية سنة 1916 بين فرنسا وبريطانيا.
وبدأت بريطانيا " التفاهم مع الحركة الصهيونية فقدم اللورد بلفور وعده المشهور سنة 1917 لليهود بانشاء وطن قومي في فلسطين. في تلك الظروف العصيبة لم تكن لسورية شخصيتها وحقوقها المثبتة في نهضة شعبية، لذلك لم تستطع الوقوف وإعلان بطلان التسويات الأجنبية السياسية – الحقوقية على حسابها. بل كانت هناك مجموعات من الأحزاب والجمعيات التي راوحت افكارها بين الإستقلال على أيدي فرنسا وبين الإستقلال التام بدون وصاية اجنبية . ومما يجدر الإشارة اليه هنا ان الفرنسيين لم يكونوا راضين عن نتيجة احتلالهم سورية. فقد انتظروا فوائد جمة من هذا الاحتلال، " وكانوا ينتظرون ان يلاقيهم الشعب بالحفاوة، ولكن القسم الكبير من السوريين عملوا بدونهم، الا بعض الاقطاعيين ورجال الدين الذين تم شراؤهم بالأموال". هذا ما يشير اليه تقرير رفعه القنصل البريطاني في بيروت في 20 فبراير 1920 وشرح فيه بالتفصيل موقف السوريين من الفرنسيين وقال " ان المسؤولين الفرنسيين ابتداء من الجنرال غورو وانتهاء بأدنى مسؤول اعربوا عن استيائهم الشديد من تصرفات أهالي بيروت الذين تمنعوا عن تأجير المنازل للفرنسيين". ولكن هذا الموقف الشعبي ما لبث ان تغير حين اعتمدت فرنسا سياسة تقوية العائلات الاقطاعية وتكريس سياسة التفرقة والتجزئة واستغلال النعرات الطائفية والعرقية. وكانت معركة ميسلون وقفة بطولية في تاريخ سورية الحديث، ولكن فرنسا في نفس الفترة كانت تقيم دولة لبنان الكبير وثم اعلنت قيام دولة حلب ودولة العلويين ودولة الدروز، هذا مع الاشارة الى ان لواء الاسكندرون قد أقيم له نظام خاص تمهيداً لفصله وضمه الى تركيا.
ولكن هذه الدويلات الي أنشئت طرأ عليها تعديل في حزيران 1922 فاتحدت فيما بينها ثم استعيض عن الاتحاد بدولتي دمشق وحلب. وبقي لبنان الكبير كيانا مستقلا عن سوريا تابعا للسيطرة الفرنسية.
غذت السياسة الفرنسية الحركات الاقتصادية في شمال سورية ولعبت المعاهد الاجنبية في سورية دورا هاما في تقديم الثقافة الإستعمارية من ضمن استراتيجية المستعمر. ولكن ردة الفعل الشعبية كانت بانفجار الثورات المتتالية من ثورة الشيخ صالح العلي وثورة هنانو، الى ثورة سنة 1925 وتحرك السوريين في فلسطين ضد سياسة الاستيطان اليهودي. وكان على شعبنا ان يواجه بوضعه الممزق بين طوائف واعراق ومذاهب واقطاعيين، ان يواجه التجزئة السياسية والاجتماعية والاستيطان اليهودي في فلسطين بأحزاب وتكتلات اعتباطية قادت الى تخبطات وتفكك روحي وتفسخ قومي. وكان سعاده يراقب أوضاع الوطن في الصحف التي تصله الى مغتربه، وفي كتاباته اكثر من اشارة الى ذلك، كما كان يراقب مجرى السياسة الدولية بدقة ووضوح ويقدم آراءه على صفحات " الجريدة" و "المجلة" في البرازيل كما كان يسعى الى "تنظيم عناصر الشباب للإتجاه نحو الأعمال الجدية والثورة" (محموعة الأعمال الرسمية للحركة القومية الاجتماعية).
الأحزاب ومطامحها
وكما أشرنا في السابق، ان الحوادث الخطيرة التي وقعت كانت تجابه بفهم خصوصي وفردي ضيق وطغيان للعصبيات الدينية وضيق أفق. وسنأخذ هنا بعض النماذج من بعض الأحزاب والأفكار الوطنية خلال تلك المرحلة.
حزب الاتحاد الدستوري : هذا الحزب الذي أسسه الأمير ميشيل لطف الله وفريق من الشبان وضعوا القواعد الأساسية له "القائمة على مبدأ الإستقلال التام" (لمراجعة مبادىء هذا الحزب يمكن قراءة كتاب امراء آل لطف الله في سنة 1920 طبع مطبعة الهلال 1920) وقد صرح رئيس هذا الحزب بعد عقد المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف الى جريدة "المقطم" القاهرية قائلا " طلبنا الإستقلال من اوربا لكل من سوريا ولبنان وفلسطين ... وأفهمنا رئيس جميعة الأمم وأعضائها ان مجموع الأمة السورية كان يطلب الحماية الفرنسوية والانكليزية وان الذين يطالبون بإستقلال بلادهم التام انما هم مدفوعون بعوامل نفوذ خارجي، وكانوا مستغربين ان تبدي الأمة السورية مثل هذا الشعور وهي على ما يعهدونه فيها من العلم والمدنية" (كتاب امراء آل لطف الله سنة 1920 ص 190 ). هكذا كان الإستقلال عن فرنسا يعد خيانة وذلك لعدم " أهليتنا للإستقلال".
نموذج آخر هو مطالب "الجمعية الوطنية السورية" التي أسسها نعمة يافت في البرازيل من مؤتمر الصلح. اذ تطلب مذكرة الجمعية من مؤتمر الصلح ان تكون الدولة التي تحمينا فرنسا لأننا لا نصلح لأن ندير حكومتنا الشعبية ولان "لفرنسا تقاليد عريقة ولان مصلحة سورية تتفق مع مصلحتها، ولان لفرنسا مركز خاص كحامية لمصالح السوريين منذ القدم ولان اثار المدنية والتهذيب الفرنسويين هي الغالبة في سوريا، ولان لفرنسا الكثير من الايادي البيضاء على السوريين في بلادهم وفي الخارج فلأجل هذه الاسباب نرى من الطبيعي ان تكون فرنسا متولية تأليف سوريا وتنظيمها ومراقبة إستقلالها الى اليوم الذي يصبح فيه الشعب السوري اهلا للاستغناء عن كل مراقبة وقادرا على ادارة شؤونه بدون مساعدة اجنبية" (كتاب نعمة يافت حياته وأعماله – سان باولو 1934 ، ص 124).
نموذج اخير عن العقلية التي تقول ان مصير سورية يقرر دائما من الخارج، مع ان هذا النموذج قد تغير الى حملة عنيفة على فرنسا ودعوة الى الإستقلال والاعتماد على النفس هو موقف الدكتور خليل سعاده مؤسس الحزب الوطني الديمقراطي في بوانس ايرس الارجنتين.
يقول الدكتور سعاده بعد انتهاء الحرب الكبرى وفي نداء موجه الى السوريين " ان فرنسا اعلنت قبل دخولها سوريا بشهور عديدة انها لا تدخلها غازية ولا تجيئها فاتحة بل تأتينا مواسية لنا وعاطفة علينا فلا بأس بان تكون فرنسا مرشدة لنا في طريق الحرية ومدربة ايانا على الحكم الذاتي على شريطة ان يكون إستقلالنا مضمونا" ( المجلة بوانس ايرس 15 تشرين الثاني 1918).
ولكن موقف الدكتور سعاده قد تغير كما قلنا بعد ظهور المطامع الإستعمارية الفرنسية وذلك باتجاه الإستقلال التام والاعتماد على النفس ولكنه وقع فيما بعد بأوهام "امبراطورية عربية" وخلط بين القول بالقومية السورية والقومية اللبنانية وقد اخذ عليه سعاده ذلك معتبرا انه غير متمكن من الشأن القومي ومعنى الأمة كغيره ممن عاصره وسبقه ، واشاد به كطليعي مناضل وذلك في رسالة الى أخيه ادوار سعاده.
هذه النماذج عن الإستقلال تحت رعاية فرنسة تبعها في العشرينات أحزاب كالكتلة الوطنية في دمشق درجت على السياسة الإعتباطية الرجعية بالتفريط والتساهل بحقوق سورية مع الفرنسيين وأفضل مثل على ذلك مسألة الإسكندرون.
يقول سعاده عن هذه الحركات التي سبقت تأسيس النهضة القومية الاجتماعية " كل اختلاجة من اختلاجات الحياة السياسية في سورية كانت خصوصية في أساسها، خصوصية في مراميها، دينية او عشائرية او محلية. كل فئة في جزء من أجزاء سورية عملت بمنهاج فئوي في دائرة محلية وساعدت الإرادات الأجنبية هذا التفسخ الواسع" (مراحل المسألة الفلسطينية ص. 50).
خاتمة
لقد ظلت الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية تجري ضمن مؤسسات المذاهب الدينية والإقطاع والعشائر وسيطرة وتواطؤ الرأسمال الأجنبي مع الرأسمال الوطني فأوجدت بذلك حالة من التفسخ القومي وأمسكت الأمة من خناقها كما يقول سعاده في مقاله "شق الطريق لتحيا سورية". ولكن هذا الوضع قد نقض بتأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ووضع حد "للفوضى السياسية والاجتماعية فلم تعد الحركة القومية مجرد انتفاض على الإرادات الأجنبية والسيطرة الأجنبية او حركة جماعة مسيحية او جماعة إسلامية بل حركة أمة ادركت وحدة مصالحها وحقيقة حياتها فأرادت هذه الحقيقة وعملت لها ". (خطاب اول آذار 1938).
ان تأسيس الحزب قد سبقه معاناة طويلة في عقل سعاده، ودراسات واسعة وثلاث تجارب تنظيمية. ودراسة سعاده العلمية لأوضاع أمته ولسير السياسة الدولية وللأخطار المهددة شعبنا، اكدت له ضرورة تأسيس حياة جديدة في نظام جديد هو نظام الحزب الذي أنشأ. وسوف نتعرض لدراسات سعاده وتجاربه في أبحاث قادمة وهذا الشرح المستفيض احيانا للأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية في سورية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين هو مدخل لقراءة سعاده بين 1920 – 1930.
التاريخ: 2021-05-30
@2025 Saadeh Cultural Foundation All Rights Reserved | Powered & Designed By Asmar Pro